ذو العَقلِ يشقى بالنَّعيمِ بعقلهِ: كيفَ يسبِقُ الإنسانَ عُمره؟
ذو التَّجارِب يرعى النّجُوم وقليلُ التَّجارِب يعيشُ هنيئًا

تأمّل في الناس، لِمَ ترى من بينهم من سبقَ سِنَّهُ وتخطّى جيله؟ تجالسهُ فتجِد في حديثه أثرَ التجارِب، وفي نظره حكمةَ العارفين، كأنّ الأيام قد أودعتْه سرَّها، صاغته التجارِبُ من حجرٍ صلدٍ حتى غدا ألماسًا نفيسًا، أودعت الأيامُ في جوفه سرَّ الصبر، وألهبته المواقفُ حتى تلألأ نوره، فلا الزمنُ يخدشه، ولا العواصفُ تنالُ من بريقه. وآخرُ يمضي به الزمانُ كما يمضي النسيم على صفحة الماء، لا يُثير موجًا ولا يُخلّف أثرًا، يعدّ الأيام ولا تعدّه، ويحسب الأعوامَ فلا تحسب له.
فكيف يعلو نجمٌ في سماءِ الحياة، وآخر يخفُت ضوؤه وإن وُلِدا في فلكٍ واحد؟ الجواب لا يكمن في الحظّ ولا في المصادفة، إنّما الفرقُ في وعيٍ تفتحُ به القلوبُ أبصارَها، لا في سنٍّ تُحصيها الأيّام، فكم من إنسانٍ مرّت به النوازل نفسها، غير أنّ أحدهما خرج منها بصيرًا، والآخر خرج منها كما دخلها، خالي الوفاض.
فبطبيعة الإنسان حين يخوض مرحلةً عصيبة، يُسارع إلى الظنِّ بأنّه من ذوي الحظّ العاثر، فيضيق صدرُه حين تشتدّ الخطوب، ويظنّ أنّ القدرَ جفاه، وأنّ الحظّ أعرض عنه، فيقعد يَقيسُ نفسه بغيره، ويُحصي ما فاته كما يُحصي الخاسرُ ما ضاع من يده. لكنّ تلك المقاييسَ لا تُقيم وزنًا للجوهر، فإنّ البلاء الذي يُنبت في القلب صبرًا، خيرٌ من النعمة التي تُورث غفلة. وليس السقيمُ من تعثّر، ولا العظيمُ من ظفر، بل من كانت تجربتُه مُرّةً هو أوفرُهم حظًّا، إذ ما خابَ من جَرّب، وما من تجربةٍ إلا وهي مرآةٌ يرى فيها العاقلُ صورتَه، فيُصلح ما اعوجّ، ويُزهر ما ذبُل؛ وأمّا الغافلُ فيمرّ بها كما تمرّ الريحُ على الصخر، لا تُغيّر فيه شيئًا.
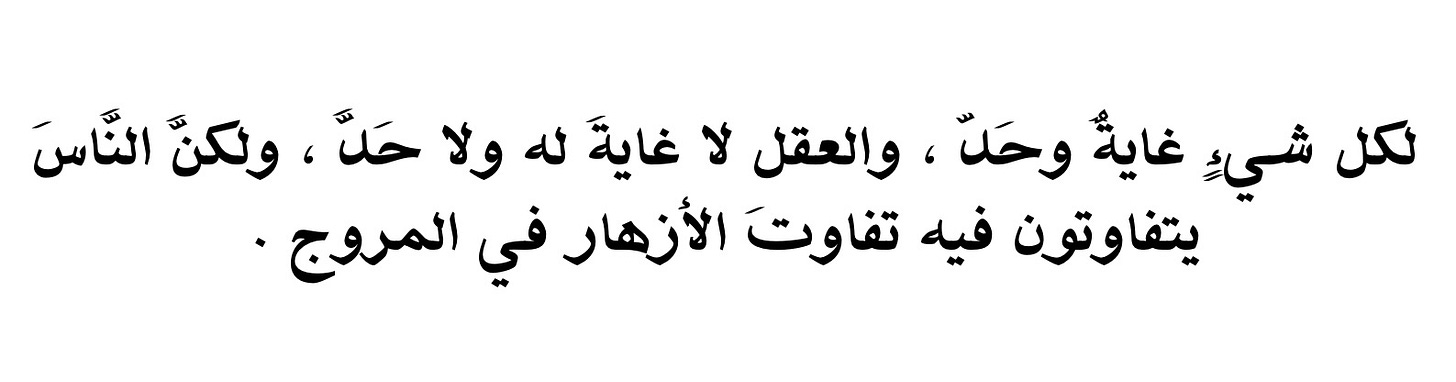
وما نحنُ إلا سفنٌ صغيرة، مركونةً إلى جانِب المَرسى، تنتظرُ أن تُحمّل بتجارُب السنين وعِبرةُ الأيّام، ثم شيئًا فشيئًا تشُق الطريق إلى بحرٍ في ظاهره أزرقٌ حالِم، وفي باطنه ظلماتٌ بعضها فوق بعض. فمن كانت سفينته فارغةً من التجارب غرق في أول موجة، ومن حملت سفينتُه زاد الصبر والتأمل، نجا وإن تكسّرت أشرعته.
ولأنّ العقل هو رُبّان هذه السفينة، قُسِّم إلى قسمين: أحدُهما العقلُ الغريزيّ، وهو ما يشترك فيه سائرُ البشر من إدراكٍ وتمييزٍ، جُبِلوا عليه منذ خُلقوا. وأما الآخر فهو العقلُ التجريبيّ، وهو المُكتسب الذي ينمو بالخبرة، ويزداد صفاءً بكثرة التجرِبة وطول الممارسة. وعلى هذا الاعتبار يُقال: إنّ الإنسان أرجحُ عقلًا، وأعمقُ فِكرًا، وأبصرُ بما تُخفيه الأيّامُ من أسرارها؛ لأنّ الليالي كشفت له ما خُفي عن غيره، وجعلت من تقلباته مرآةً للحكمة.
وإننا لا ندرك حينها أثر ما نمُرُّ به من تجارب، لكن الله يودع في قلوبنا من الحكمة ما يُعيننا على التمييز بين الحق والباطل، بين دُجى الليل وظلاله، حتى تشرق الشمس بخيوطها الأولى، فيُصقل فينا نور الصباح، فنُصبح من أهل الوعي والرشد.
غير أنّ كثرة التجارب لا تهبُ العقلَ بصيرتَه ما لم تُصاحبها وقفةُ تأملٍ صادقة، فكم من مُسنٍّ لم يزده العمرُ إلا غفلة، وكم من فتىً قصيرِ السنين قد فاق عقلُه أهل التجارب دهاءً وفِطنة. فالعقل لا يُقاس بعدد الأعوام، بل بقدرته على التقاط العِبرة من أدقّ الوقائع، وفهم مقاصدها الخفية في وعيٍ متأمّل.
العقلُ سفينةٌ تمخرُ عُبابَ الحياة، تجري بما حُمِّلت من مشاعرٍ وتجارب، وتقلّ في جوفها أثقال الفكر ووهجَ الشعور.
تمضي بين موجاتِ الشكّ واليقين، ورياحِ الخوفِ والرجاء، تارةً تسكنها الطمأنينة، وتارةً تُهيجها العواصفُ والأوهام.
فهذا يُنادي بأنّ من غادر أرضًا غير أرضه قد نجا، وذاك يُحذّر من ارتفاع الموج لئلّا يغرق مَن في السفينة، وآخرُ يُلقي بطَوق نجاةٍ جاء متأخّرًا عن أوانه. فإن اعتدل ميزانها بين القلب والعقل، رست على شاطئ النجاة، وإن مال أحدُهما على الآخر، اضطربت أمواجها وزاغت بوصلتها عن سواء السبيل. وكثيرون اغترّوا بما ترسمه خرائطُ الظاهر، وهي لا تُظهر إلّا سطح البحر، أمّا أعماقُه فلا يدركها إلّا من غاص في بحار التجربة، ولامس بيده جوهرَ الحقيقة، فعاد إلى المرسى وقد استبان له الطريق.


بوركت الأنامل، أعتبر الوعي أو التفكّر في تجارب الحياة ومعرفة الحِكمة منها والتبصر بما كتب الله لنا والرضا به من النعم التي لا تُسخر للجميع.. ورغم الألم المصاحب لها إلا أنها رحمة كبيرة من رب العالمين، فالبصيرة نورٌ يُقذف في قلب العبد..
لن أكتفي هنا. كلامٌ في غاية الرقة وفيه بلاغة وحكمة، إن دلّت دلّت على رجل في التفكير شابّ، ومن استيعابه استطاب. كانت من أمتع ما قرأت.